يُعد القرن التاسع عشر بمثابة قرن التأسيس للأحزاب السياسية في المشرق العربي، ونعني بذلك ان الفكر العربي بدأ يتشكل مساره من الحقل المعرفي الى (المحاولات) لصياغة فكر ايديولوجي جديد، والتي حاولت إستنهاض الفكر المخزون وإرادة الأمة، من خلال ترجمة التراث العربي والإسلامي الى فعل سياسي، في مسعى منها (أي المحاولات) لردم الهوة بين تاريخين هما، تاريخ ذهبي مزدهر (عصر النهضة) وتاريخ مهزوم منكسر (عصر الانحطاط).
دونت المرحلة الاولى من مراحل الاستنهاض في أول محاولة لتنظيم سياسي، فكان تأسيس حزب (الشباب العثماني) في اسطنبول أولاً من سنة 1860 والتي وصفها البعض بأنها كانت المحاولة الأخطر خطوة والأشد جرأة. نعم وان كان التأسيس في تركيا العثمانية آنذاك، الاّ ان أساس انبثاق ولادة الفكرة كرؤية استشرافية كانت في افريقيا العربية والتي تُعد باكورة ترجمة المقولات السياسية الى عمل سياسي حزبي محايث للواقع. اذ كانت الأمة العربية في هذه الفترات تعيش ارهاصات مكثفة من الانتقال المرحلي للتنوير الذي يحقق الازدهار والابداع في المنطقة الاسلامية.
هذه الإرهاصات من التاريخ العربي الاسلامي، هي بمثابة ردود فعل للاحداث السياسية الكبيرة في أوروبا وأهمها الثورة الفرنسية التي خلّفت ثورات معرفية وعلمية كبيرة توزعت على القطاعات التكنولوجية والاقتصادية والزراعية حتى أدت الى نهضة عمرانية نقلت أوروبا الى عصر التحرر العقلي والسلوكي، وكسر القيود، والتي غالباً ما كانت تتصف بتاريخ من القهر وعلوية الطبقات الارستقراطية ودوغما الاوهام، والتحوّل نحو قيادة الشعوب والمؤسسات العلمية والمعرفية وصياغة النظريات السياسية فضلاً عن الاقتصادية منها، والتوجه العربي كذلك نحو نظرية المعرفة والماكنة الصناعية والفلسفات الليبرالية في محاولة الاستفادة، وادخالها في وحدة الحضارة والمدنية والثقافة وفي بناء المؤسسات العصرية.
كان المفكرون العرب والمسلمون في هذه الحقبة التاريخية يهتمون بالسفر والتجوال السياحي والمعرفي، من قبيل رافع الطهطاوي والأفغاني ومحمد عبده، مما أظهرَ تأثرهم الكبير بالحضارة الغربية، من خلال قراءة تاريخ الشعوب ومنظوماتها السياسية التي تعمل على تعزيز كرامة الانسان والمواطن، حتى أمتد اثر التقدم الاجتماعي في الغرب الى ظهور الدولة الكمالية في تركيا، والتي وضعت حداً لنظام الخلافة العثمانية رسميا سنة 1925، واقامت محلها نظاماً علمانياً جذرياً على منوال الثورة الفرنسية.
مما أدى الى طرح هذه الأفكار والرؤى الحديثة والتي تطورت فيما بعد الى صدامات فكرية وتنازعات جماعاتية، صورت الأفكار الجديدة بأنها انقلاب على التراث التاريخي والقيمي والاجتماعي ومسخ الاصالة والتراث بقيم عصرية مدعومة غربياً.
تغيّر المشهد السياسي على اثر ذلك في المنطقة، بين مَن كانت عينه على تركيا الشرقية حاضنة تاريخ دولة الخلافة العثمانية، ومن عينه على تركيا الأوربية صانعة الدولة المدنية بنظام علماني. حتى اندفعت الإرادة العربية نحو صناعة وإحياء الهوية الإسلامية في محاولة منها، إيقاف هاجس الخوف من محو التاريخ الديني ووجوده الحاضر في السلوكيات اليومية.
تأسست على اثر ذلك عدة احزاب إسلامية في المنطقة، اذ توزعت بين مصر وشمال افريقيا والعراق. يمثل هذا التأسيس حالة اليقظة التي جاءت بعد مخاض اجتماعي طويل والنزاع النفسي الذي كانت تعانيها النخبة، وهو الخوف من ضياع الهوية الإسلامية، ولا نستبعد كذلك الصراع الايديولوجي في صعود الهويات بين المشاريع الايديولوجية ومنها القومية/العروبية- والإسلامية ثم العلمانية التي تعد اضعف اضلاعها الثلاثة، (اترك الكتابة عن أثر الماركسية/الشيوعية/الاشتراكية من بحثية المقال، لزمن آخر، اذ يمكن ان نصف ذلك بالفكر المركب المشحون بمسارات فكرية متعددة).
لم يكن العراق بعيداً عن رحم ولادات الاحزاب السياسية وهو الجزء الأسمى من فرضية ارض الخصيب، التي يُعتقد انها الأرض المترفة الخلاّقة في رسم هيكلية النظرية القومية العربية. مع اضافة العامل الديني الحيوي الذي يشتغل أصحابها على مقولة الحتمية الدينية (للتاريخ المتحرك) في دول ارض الخصيب.
ابتدأ الصراع الايديولوجي الثاني في العراق بين اهم ثلاث تيارات فكرية هي: الشيوعية/القومعلمانية/الإسلامية.
اذ ترى الشيوعية ان حل مشكلة الانسان يبدأ من خلال الأولويات التي تاخذ الجزء الكبير من الفكر السياسي والاجتماعي لمعرفة المرحلة التي يعيشها المجتمع وعمر الزمن الذي يحقق المسقبل المنتظر من تحرير الانسان واستعباده تحت مظلة الرأسمالية والتي جعلت من الفرد آلة إنتاجية تزيد من الأرباح للمصنع الرأسمالي وتقسيم المجتمع إلى أسياد وعبيد. لم تفلح هذه النظرية التي اعتقد ان احد الاسباب يعود الى ان الأغلبية لم تفهم فلسفة كارل ماركس ولا انجلز الاّ في حدود ضيقة جداً، (يمكن مراجعة موقف بليخانوف وانساحبه من العمل السياسي آنذاك).
شكّل الفكر القومي العروبي والعلماني البعد الآخر الذي وجد لنفسه المساحة المكانية البشرية في أن يجرّب أفكاره ورؤاه من خلال عاملين هما: استيعاب الناس والتجربة السياسية العملية. ومن المهم جداً أن لا نخلط بين التيارين القومي والعلماني اذ لكل منهما أدواته الفكرية والسياسية وبيئته الذي جاء منها. ومن الملفت للمتابع، انه اذا ما أخذ الواحد من الآخر بعض الجزئيات أو تشابها في بعض التطبيقات، فإنه لا يعني ذلك أن يتبادلا الاسماء أو يدمجا معاً تحت ايديولوجية واحدة. وجهت هذه التيارات الفكرية/السياسية بتيار إسلامي قد امتد بزمن قياسي وأخذ مساحة واسعة في نشر أفكاره التي اختزلها في: الإسلام دين ودولة / الإسلام هو الحل.
لم يكن طرح الايديولوجيات السياسية الدينية بالأمر الجديد (في الجغرافية العربية) او بالأمر المستغرب على المشهد الدولي التاريخي السياسي الحديث والمعاصر، بل كانت اوروبا هي الرائدة في صناعة الاطروحات والنظريات السياسية التي استطاعت أن تخلق جيلاً كبيراً يتفاعل طردياً مع مفاهيم الدولة ومبادئ حقوق الانسان والعمل والتمهيد للسلام الشامل.
الاّ ان الركائز التي تعتمدها الاحزاب الدينية كانت هي الاكثر تعقيداً من الاحزاب السياسية غير الدينية وهذا يرجع الى مساحة افق العمل لهما، ممكن ان نسميها بالاحزاب الارضية (نسبة الى مدينة الارض)، (احزاب النص الذي يواكب طبيعة الحياة ويتعامل معها براغماتياً) في مواجهة الاحزاب الاخروية (نسبة الى مدينة السماء)، (اصحاب النص الذي لا ينفصم عن تأريخ التأسيس والتراث الديني).
يعني ذلك ان الاحزاب السياسية التي تتخذ من الفلسفة السياسية اطاراً حيوياً لفهم الواقع والتعامل مع متبنياته، التي تمتد مساحة عملها على طول الواقع المرئي المحسوس، وهي الأكثر حرية في التمظهر، بخلاف الاحزاب الدينية التي تمتد مساحة عملها الى مابعد هذا العالم المرئي وانتاج المفاهيم التي تلزم المواطن، وتقلل من مساحة حرية الفرد في الواقع المعاش. قد تحسب وحدات فسحة الحريات وفق تعدد الرؤى والمفاهيم، لا النسبانية بتعبير ايزيا برلين والتي تنضبط مع قواعد النصوص التي تعتمدها في سلوكها السياسي العملي.
استمر التأسيس الموسوم بالصراع والمجابهة وتفاقم الازمات والتي انعكست سلباً على علاقة المجتمع بالدولة، في محاولة منها انتاج دولة بمفاهيم قيمية وتاريخية مشحونة بالعاطفة والغلبة التي تريد من خلالها اثبات الهوية وحضور الذات.
خمسون عاماً كانت كافية لاختبار هذه النظريات في الواقع ومعرفة قوة الايديولوجيات ومقوماتها التي تعتبر المغذيات أو المحركات للفعل السياسي. منها ما أفلت ومنها ما أُكلت ومنها ما صارت عوداً فتيبست، الأسباب كثيرة ومعقدة، الا ان اهمها هو ان الواقع اعقد بكثير من الافكار التي تتركب وفق سياق المنطق الفكري أو التنظيري، والذي يثبت مرة اخرى صعوبة احتواء الواقع والتعامل معه وفق قاعدة التعميم من خلال التجارب المحدودة التي تستخلص منها نتيجة مطلقة.
وعلى اثرِ هذا التاريخ السياسي، تم التسويق والترويج لنظرية نهاية التاريخ والانسان الاخير، الذي يختزل الفكرة الحية للنظرية السياسية الليبرالية من حيث معالجة مشكلات الانسان اليومية والكيانية. وكان رداً صارخاً على ازمات الدول والشعوب ودعوة الى الانضمام الأممي للنظرية السياسية الليبرالية التي استطاعات أن تعالج مشكلة الانسان والاستفادة من دورة الفشل وتعويض مناطق الضعف الديناميكي الذي يتفاعل من خلاله المواطن مع مؤسسات الدولة.


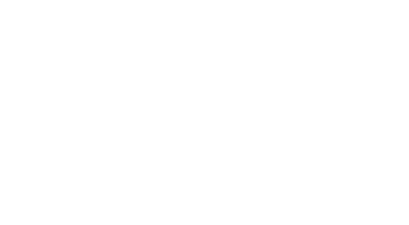





تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً